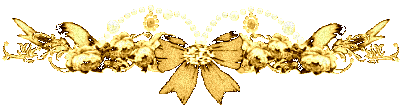أم أمة الله
بيانات العضوة
- رقم العضوية : 87979
- تاريخ التسجيل: 123Apr 2015
- الدولة : مصر
- المدينة : مصر
- الحالة الاجتماعية : متزوجة
- الوظيفة : ليسانس لغة عربية
- المشاركات: 21,568 [+]
- الأصدقاء : 195
- نقاط التقييم : 6850
 المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم

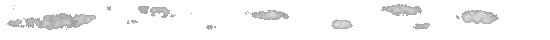
 أهلاً بكـــم أخواتى الغاليات فى مسابقة اليـــــــــ
أهلاً بكـــم أخواتى الغاليات فى مسابقة اليـــــــــ ــــــوم
ــــــوم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 أهلاُ بكم ومرحباً
أهلاُ بكم ومرحباً 
أطال الله أعماركم مع حسن العمل

بارك الله فيكن
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 اولاُ/ ليسهل عليكم الإشتراك فى المسابقة ستكون يوم ويوم
اولاُ/ ليسهل عليكم الإشتراك فى المسابقة ستكون يوم ويوملتأخذى فرصة فى الحل
لنبدأ المسابقة ربنا ينور طريقكم ويفتح عليكم ويجعله فى ميزان حسناتكم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
بالتوفيق لكنَّ جميعاً

توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
العدولة هدير
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم الشرع في جلسات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم (الموالد)، ويذكر فيها على سبيل المثال: يا رسول الله يا مفرج الهم والكرب؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه بالشعر والنثر، وفي الخطب والمواعظ والدروس كل ذلك جائز حسن، ما لم يشتمل ذلك على محظور شرعاً، ومن ذلك أن يشتمل المديح للنبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى كما جاء في سؤال السائل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " رواه البخاري .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في الفتاوى 1/96: فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى.
ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جويريات يقلن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) قال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوحيد: 1/71 وقد دل الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة. أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ أو الأساتذة فتخطوا في ذلك حدود الشرع انتهى.
فالحاصل أن مدحه صلى الله عليه وسلم حسن، ما لم يشتمل على غلو أو كذب. قال الإمام الرحيباني في مطالب أولى النهى: (2/501) عن الشعر: ويباح إن كان حكما وأدباً ومواعظ وأمثالاً، أو لغة يستشهد بها على تأويل القرآن والحديث، أو مديحاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بما لا كذب فيه.
معنى الغلو في حب النبي -صلى الله عليه وسلم
الغلو الزيادة بأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا غلو، تقول: غلى القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار، الغلو معناه الزيادة في غير المشروع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، والله يقول -سبحانه-: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ[النساء: 171]، فالغلو الزيادة في المحبة، في الأعمال التي شرعها الله، يقال له: غلو، مثلاً تقول الله افترض علينا خمس صلوات، أنا أحط سادسة ........ وأوجبها على الناس، أنت مثلاً سلطان أو أمير تقول: ..... زيادة خير صلاة سادسة هذا ما يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا غلو، أو تقول: أنا أحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فأدعوه من دون الله، أقول يا رسول الله اشفي مريضي وانصرني بعد موته، هذا غلو، ..... الله، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ادعو الله، أمرك أن تدعو الله، ما أمرك أن تدعوه، أمرك أن تدعو الله، والله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[غافر: 60]، فعليك أن تدعو الله لا تسأل الرسول، ويقول -جل وعلا-: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[المؤمنون: 117]، فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر، هذا من الغلو, ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله من سائر العبادات، شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، تزيد أنت توسل بجاه النبي، أو ببركة النبي، أو بحق النبي، هذا بدعة هذا غلو، لكن توسل بالأعمال الصالحة، بحبك للنبي نعم، اللهم إني أسألك بحب نبيك، بمحبتي نبيك، بإيماني بنبيك هذا طيب، هذه وسيلة شرعية، لكن بجاه نبيك هذه ماله أصل، بحق نبيك هذا ما هو مشروع، ببركة نبيك هذا ما هو مشروع، المشروع أن تتوسل بمحبتك، بإيمانك به، باتباعك له، بطاعتك له، هذه الوسيلة الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان بالله ورسوله.
المراجع
الاسلام ويب
موقع الامام بن باز
توقيع : العدولة هدير
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات العدولة هدير
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 39,434
- العدولة هدير
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى العدولة هدير
حنين الروح123
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
توقيع : حنين الروح123
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات حنين الروح123
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 12,519
- حنين الروح123
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى حنين الروح123
حنين الروح123
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
الغلو الزيادة بأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا غلو، تقول: غلى القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار، الغلو معناه الزيادة في غير المشروع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، والله يقول -سبحانه-: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ[النساء: 171]، فالغلو الزيادة في المحبة، في الأعمال التي شرعها الله، يقال له: غلو، مثلاً تقول الله افترض علينا خمس صلوات، أنا أحط سادسة ........ وأوجبها على الناس، أنت مثلاً سلطان أو أمير تقول: ..... زيادة خير صلاة سادسة هذا ما يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا غلو، أو تقول: أنا أحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فأدعوه من دون الله، أقول يا رسول الله اشفي مريضي وانصرني بعد موته، هذا غلو، ..... الله، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ادعو الله، أمرك أن تدعو الله، ما أمرك أن تدعوه، أمرك أن تدعو الله، والله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[غافر: 60]، فعليك أن تدعو الله لا تسأل الرسول، ويقول -جل وعلا-: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[المؤمنون: 117]، فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر، هذا من الغلو, ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله من سائر العبادات، شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، تزيد أنت توسل بجاه النبي، أو ببركة النبي، أو بحق النبي، هذا بدعة هذا غلو، لكن توسل بالأعمال الصالحة، بحبك للنبي نعم، اللهم إني أسألك بحب نبيك، بمحبتي نبيك، بإيماني بنبيك هذا طيب، هذه وسيلة شرعية، لكن بجاه نبيك هذه ماله أصل، بحق نبيك هذا ما هو مشروع، ببركة نبيك هذا ما هو مشروع، المشروع أن تتوسل بمحبتك، بإيمانك به، باتباعك له، بطاعتك له، هذه الوسيلة الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان بالله ورسوله.
ما مدى صحة قول بعض المنشدين: محمد قبلة الدنيا وكعبتها. و: ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله
على أن اسم طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذه الألفاظ مخالفة للدين أم أنها من المباحات؟ علما أنها تنشد بدون دف. أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. متفق عليه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله. رواه البخاري.
قال ابن حجر: الْإِطْرَاء الْمَدْح بِالْبَاطِلِ، تَقُول: أَطْرَيْت فُلَانًا، مَدَحْته فَأَفْرَطْت فِي مَدْحه. اهـ.
ولما قال وفد بني عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
قال ابن الأثير في النهاية: أي لا يَسْتَغْلِبَنَّكم فيتَّخِذكم جَرِيًّا: أي رَسُولا ووكِيلاً. وذلك أنهم كانوا مَدَحُوه فكَرِه لهم المبالغَة في المدْح فنَهاهُم عنه.
وَفِي النِّهَايَة :أَيْ لَا يَغْلِبَنكُمْ فَيَتَّخِذكُمْ جَرْيًا أَيْ رَسُولًا وَوَكِيلًا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَدَحُوهُ فَكَرِهَ لَهُمْ الْمُبَالَغَة فِي الْمَدْح فَنَهَاهُمْ عَنْهُ. اهـ.
وقال السِّنْدِيُّ: أَيْ لَا يَسْتَعْمِلَنكُمْ الشَّيْطَان فِيمَا يُرِيد مِنْ التَّعْظِيم لِلْمَخْلُوقِ بِمِقْدَارِ لَا يَجُوز. اهـ.
فينبغي الحذر من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة المدح الذي يصل بالعبد لدرجة الشرك أو يكون ذريعة له.
ومقولة: محمد قبلة الدنيا وكعبتها. وإن كان يمكن أن يؤول معناها بحيث لا يكون فيها خطأ ولا انحراف، إلا أنها ينطبق عليها الحديث السابق: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
وأما مقولة: ودعوت بطه الله. فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 116496. أن هذه العبارة نوع من التوسل، والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحقه، أو جاهه، أو صفته، أو بركته، من أنواع التوسل الممنوعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو بدعة لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وفيها التنبيه على أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
توقيع : حنين الروح123
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات حنين الروح123
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 12,519
- حنين الروح123
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى حنين الروح123
بحلم بالفرحة
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
☆☆☆☆☆☆☆☆
الجواب:
الحمد لله
"حكم هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : أن يكون مدحاً فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو ، فهذا لا بأس به ، أي : لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ، من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم.
والقسم الثاني: من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله) . فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم ، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يجوز أن يمدح الرسول، عليه الصلاة والسلام، بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول أيضاً : إن هذا حرام ولا يجوز ، لأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة ، والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله ، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا ، لقول الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/15، 16. والله الهادي إلى سواء الصراط" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (1/258) .
الإسلام سؤال وجواب
توقيع : بحلم بالفرحة
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات بحلم بالفرحة
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 2,574
- بحلم بالفرحة
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى بحلم بالفرحة
بحلم بالفرحة
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
توقيع : بحلم بالفرحة
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات بحلم بالفرحة
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 2,574
- بحلم بالفرحة
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى بحلم بالفرحة
النجمة الذهبية
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
السؤال
السؤال: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات:
يا سيدي يا رسول الله يا سندي ** يا واسع الفضل والإحسان والمدد
يا من هو المرتجى في كل نازلة ** ومن هو المورد الأحلى لكل صدِ
يمناك فوق البحار الزاخرات ندىً *** تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد
كم شدة أنت كافيها وكم محن *** حلت يمينك منها سائر العقد
يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي *** في القلب والجسم آلام تعاودني
إذا نظرت إليها اليوم لم تعـــــد *** أأشتكي الضيق والحرمان في بلد
فيها غياث البرايا منحة الصمد *** فيها الحبيب الذي ترجى شفاعته
ويستجار به في أعظم الشـــــــدد *** كل المطالب والحاجات إن فقدت
فإنها ترتجى في هذه البلد *** يا آخذاً بيد الملهوف هاك يدي
مبسوطة لسؤال العطف والمدد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعياذا بالله ثم عياذا به من هذا الكلام القبيح المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه الأبيات على شيء عظيم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه ووصفه بما هو مختص بالرب تبارك وتعالى من كونه المرتجى في النوازل والمؤمل في الشدائد، وأنه غياث البرايا ونحو ذلك من الأوصاف التي لا يستحق أن يوصف بها إلا الله وحده، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص والدين الحنيف النقي عن أدران الشرك، وحذر أمته من الغلو فيه أو في غيره صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ونهى أمته عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم مبينا لهم أنه عبد وأن يقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه الله تعالى حين دعا على بعض الناس بقوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ{آل عمران:128}.
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
توقيع : النجمة الذهبية
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات النجمة الذهبية
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 2,397
- النجمة الذهبية
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى النجمة الذهبية
لؤلؤة الحَياة
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
ما هو حكم الشرع في جلسات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم (الموالد)، ويذكر فيها على سبيل المثال: يا رسول الله يا مفرج الهم والكرب؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
***********************************************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه بالشعر والنثر، وفي الخطب والمواعظ والدروس كل ذلك جائز حسن، ما لم يشتمل ذلك على محظور شرعاً، ومن ذلك أن يشتمل المديح للنبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى كما جاء في سؤال السائل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " رواه البخاري .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في الفتاوى 1/96: فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى.
ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جويريات يقلن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) قال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوحيد: 1/71 وقد دل الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة. أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ أو الأساتذة فتخطوا في ذلك حدود الشرع انتهى.
فالحاصل أن مدحه صلى الله عليه وسلم حسن، ما لم يشتمل على غلو أو كذب. قال الإمام الرحيباني في مطالب أولى النهى: (2/501) عن الشعر: ويباح إن كان حكما وأدباً ومواعظ وأمثالاً، أو لغة يستشهد بها على تأويل القرآن والحديث، أو مديحاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بما لا كذب فيه.
أما حكم الاحتفال بالموالد فقد تقدم الجواب عنه برقم: 1741 فراجعه.
والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات:
يا سيدي يا رسول الله يا سندي ** يا واسع الفضل والإحسان والمدد
يا من هو المرتجى في كل نازلة ** ومن هو المورد الأحلى لكل صدِ
يمناك فوق البحار الزاخرات ندىً *** تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد
كم شدة أنت كافيها وكم محن *** حلت يمينك منها سائر العقد
يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي *** في القلب والجسم آلام تعاودني
إذا نظرت إليها اليوم لم تعـــــد *** أأشتكي الضيق والحرمان في بلد
فيها غياث البرايا منحة الصمد *** فيها الحبيب الذي ترجى شفاعته
ويستجار به في أعظم الشـــــــدد *** كل المطالب والحاجات إن فقدت
فإنها ترتجى في هذه البلد *** يا آخذاً بيد الملهوف هاك يدي
مبسوطة لسؤال العطف والمدد.
***********************************************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعياذا بالله ثم عياذا به من هذا الكلام القبيح المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه الأبيات على شيء عظيم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه ووصفه بما هو مختص بالرب تبارك وتعالى من كونه المرتجى في النوازل والمؤمل في الشدائد، وأنه غياث البرايا ونحو ذلك من الأوصاف التي لا يستحق أن يوصف بها إلا الله وحده، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص والدين الحنيف النقي عن أدران الشرك، وحذر أمته من الغلو فيه أو في غيره صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ونهى أمته عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم مبينا لهم أنه عبد وأن يقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه الله تعالى حين دعا على بعض الناس بقوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ{آل عمران:128}.
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
توقيع : لؤلؤة الحَياة
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات لؤلؤة الحَياة
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 8,648
- لؤلؤة الحَياة
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى لؤلؤة الحَياة
حنين الروح123
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
توقيع : حنين الروح123
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات حنين الروح123
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 12,519
- حنين الروح123
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى حنين الروح123
جنا حبيبة ماما
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
توقيع : جنا حبيبة ماما
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات جنا حبيبة ماما
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,734
- جنا حبيبة ماما
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى جنا حبيبة ماما
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العدولة هدير
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو حكم الشرع في جلسات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم (الموالد)، ويذكر فيها على سبيل المثال: يا رسول الله يا مفرج الهم والكرب؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه بالشعر والنثر، وفي الخطب والمواعظ والدروس كل ذلك جائز حسن، ما لم يشتمل ذلك على محظور شرعاً، ومن ذلك أن يشتمل المديح للنبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى كما جاء في سؤال السائل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " رواه البخاري .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في الفتاوى 1/96: فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى.
ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جويريات يقلن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) قال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوحيد: 1/71 وقد دل الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة. أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ أو الأساتذة فتخطوا في ذلك حدود الشرع انتهى.
فالحاصل أن مدحه صلى الله عليه وسلم حسن، ما لم يشتمل على غلو أو كذب. قال الإمام الرحيباني في مطالب أولى النهى: (2/501) عن الشعر: ويباح إن كان حكما وأدباً ومواعظ وأمثالاً، أو لغة يستشهد بها على تأويل القرآن والحديث، أو مديحاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بما لا كذب فيه.
معنى الغلو في حب النبي -صلى الله عليه وسلم
الغلو الزيادة بأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا غلو، تقول: غلى القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار، الغلو معناه الزيادة في غير المشروع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، والله يقول -سبحانه-: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ[النساء: 171]، فالغلو الزيادة في المحبة، في الأعمال التي شرعها الله، يقال له: غلو، مثلاً تقول الله افترض علينا خمس صلوات، أنا أحط سادسة ........ وأوجبها على الناس، أنت مثلاً سلطان أو أمير تقول: ..... زيادة خير صلاة سادسة هذا ما يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا غلو، أو تقول: أنا أحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فأدعوه من دون الله، أقول يا رسول الله اشفي مريضي وانصرني بعد موته، هذا غلو، ..... الله، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ادعو الله، أمرك أن تدعو الله، ما أمرك أن تدعوه، أمرك أن تدعو الله، والله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[غافر: 60]، فعليك أن تدعو الله لا تسأل الرسول، ويقول -جل وعلا-: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[المؤمنون: 117]، فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر، هذا من الغلو, ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله من سائر العبادات، شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، تزيد أنت توسل بجاه النبي، أو ببركة النبي، أو بحق النبي، هذا بدعة هذا غلو، لكن توسل بالأعمال الصالحة، بحبك للنبي نعم، اللهم إني أسألك بحب نبيك، بمحبتي نبيك، بإيماني بنبيك هذا طيب، هذه وسيلة شرعية، لكن بجاه نبيك هذه ماله أصل، بحق نبيك هذا ما هو مشروع، ببركة نبيك هذا ما هو مشروع، المشروع أن تتوسل بمحبتك، بإيمانك به، باتباعك له، بطاعتك له، هذه الوسيلة الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان بالله ورسوله.
المراجع
الاسلام ويب
موقع الامام بن باز
لا تنسي تقييم اخواتك نفع الله بكِ ياغالية
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
العدولة هدير
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أمة الله
لا تنسي تقييم اخواتك نفع الله بكِ ياغالية
توقيع : العدولة هدير
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات العدولة هدير
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 39,434
- العدولة هدير
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى العدولة هدير
amira alzlam
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب، ثم قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، ونسخ العلم، عبدت) (2) .
ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب؛ لئلا يؤدي به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر.
ومن أنواع الغلو المحرم في حق الصالحين والذي يوصل إلى الشرك:
أولاً: المبالغة في مدحهم، كما يفعل كثير من الرافضة، وقلدهم في ذلك كثير من الصوفية، وقد أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في الشرك الأكبر في الربوبية، وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون، وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد، وأنهم يجيبون دعاءه، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعلمون الغيب، مع أنه ليس لديهم دليل واحد يتمسكون به في هذا الغلو، سوى أحاديث مكذوبة أو واهية ومنامات، وما يزعمونه من الكشف إما كذباً، وإما من أثر تلاعب الشيطان بهم، وقد أدى بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاً، فدعو الأموات من دون الله، واستغاثوا بهم، وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، فإنما أنا عبد فقولون: عبد الله ورسوله)) (3) ، رواه البخاري، وإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من البشر أولى أن لا يزاد في مدحهم، فمن زاد في مدحه صلى الله عليه وسلم أو في مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى، ومن دعا إلى هذا الغلو وأصر عليه بعد علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد سنته صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام، وإلى اتباع وتقليد اليهود والنصارى في ضلالهم وغلوهم في أنبيائهم، والذي نهاهم الله تعالى عنه.
والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كبيرة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى أن يكذب ويزور الناس له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه.
ثانياً: تصوير الأولياء والصالحين: من المعلوم أن أول شرك حدث في بني آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم، كما حصل من قوم نوح عليه السلام، ...
ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على المصورين، وتدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله.
ومن النصوص الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) (4)
رواه البخاري ومسلم، وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه أتاه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم)) (5)
وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له.
وثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (6) . رواه مسلم
ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن لا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه، سواء منه ما كان مجسماً، كالتماثيل وغيرها مما له ظل – وهو أشد حرمة وأعظم إثماً – أم ما كان على ورق, أو جدار, أو خرقة أو غيرها، ويعظم خطر التصوير إذا كان المصور من كبار أهل العلم، أو ممن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس.
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة, أو ورقة, أو تمثال، وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك، وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير... فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له، وتعلق به في الغالب، خصوصاً إذا كان المصور له شأن من سلطة, أو علم, أو صلاح، وخصوصاً إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط, أو إقامتها في شارع أو ميدان، فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين، ثم هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله)
[mention=87979]أم أمة الله[/mention];
توقيع : amira alzlam
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات amira alzlam
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 1,106
- amira alzlam
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى amira alzlam
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العدولة هدير
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amira alzlam
وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب، ثم قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، ونسخ العلم، عبدت) (2) .
ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب؛ لئلا يؤدي به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر.
ومن أنواع الغلو المحرم في حق الصالحين والذي يوصل إلى الشرك:
أولاً: المبالغة في مدحهم، كما يفعل كثير من الرافضة، وقلدهم في ذلك كثير من الصوفية، وقد أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في الشرك الأكبر في الربوبية، وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون، وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو من بعد، وأنهم يجيبون دعاءه، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعلمون الغيب، مع أنه ليس لديهم دليل واحد يتمسكون به في هذا الغلو، سوى أحاديث مكذوبة أو واهية ومنامات، وما يزعمونه من الكشف إما كذباً، وإما من أثر تلاعب الشيطان بهم، وقد أدى بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاً، فدعو الأموات من دون الله، واستغاثوا بهم، وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام، فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، فإنما أنا عبد فقولون: عبد الله ورسوله)) (3) ، رواه البخاري، وإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من البشر أولى أن لا يزاد في مدحهم، فمن زاد في مدحه صلى الله عليه وسلم أو في مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى، ومن دعا إلى هذا الغلو وأصر عليه بعد علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد سنته صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام، وإلى اتباع وتقليد اليهود والنصارى في ضلالهم وغلوهم في أنبيائهم، والذي نهاهم الله تعالى عنه.
والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كبيرة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى أن يكذب ويزور الناس له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه.
ثانياً: تصوير الأولياء والصالحين: من المعلوم أن أول شرك حدث في بني آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم، كما حصل من قوم نوح عليه السلام، ...
ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على المصورين، وتدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله.
ومن النصوص الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) (4)
رواه البخاري ومسلم، وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه أتاه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم)) (5)
وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له.
وثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (6) . رواه مسلم
ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن لا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه، سواء منه ما كان مجسماً، كالتماثيل وغيرها مما له ظل – وهو أشد حرمة وأعظم إثماً – أم ما كان على ورق, أو جدار, أو خرقة أو غيرها، ويعظم خطر التصوير إذا كان المصور من كبار أهل العلم، أو ممن لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس.
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة, أو ورقة, أو تمثال، وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة لذلك، وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير... فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له، وتعلق به في الغالب، خصوصاً إذا كان المصور له شأن من سلطة, أو علم, أو صلاح، وخصوصاً إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط, أو إقامتها في شارع أو ميدان، فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين، ثم هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله)
@أم أمة الله;
تقييمى لكِ ياغالية
ولا تنسي تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير @amira alzlam;
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين الروح123
الغلو الزيادة بأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا غلو، تقول: غلى القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار، الغلو معناه الزيادة في غير المشروع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)، والله يقول -سبحانه-: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ[النساء: 171]، فالغلو الزيادة في المحبة، في الأعمال التي شرعها الله، يقال له: غلو، مثلاً تقول الله افترض علينا خمس صلوات، أنا أحط سادسة ........ وأوجبها على الناس، أنت مثلاً سلطان أو أمير تقول: ..... زيادة خير صلاة سادسة هذا ما يجوز، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا غلو، أو تقول: أنا أحب النبي -صلى الله عليه وسلم- فأدعوه من دون الله، أقول يا رسول الله اشفي مريضي وانصرني بعد موته، هذا غلو، ..... الله، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ادعو الله، أمرك أن تدعو الله، ما أمرك أن تدعوه، أمرك أن تدعو الله، والله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[غافر: 60]، فعليك أن تدعو الله لا تسأل الرسول، ويقول -جل وعلا-: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[المؤمنون: 117]، فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر، هذا من الغلو, ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله من سائر العبادات، شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة، تزيد أنت توسل بجاه النبي، أو ببركة النبي، أو بحق النبي، هذا بدعة هذا غلو، لكن توسل بالأعمال الصالحة، بحبك للنبي نعم، اللهم إني أسألك بحب نبيك، بمحبتي نبيك، بإيماني بنبيك هذا طيب، هذه وسيلة شرعية، لكن بجاه نبيك هذه ماله أصل، بحق نبيك هذا ما هو مشروع، ببركة نبيك هذا ما هو مشروع، المشروع أن تتوسل بمحبتك، بإيمانك به، باتباعك له، بطاعتك له، هذه الوسيلة الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان بالله ورسوله.
ما مدى صحة قول بعض المنشدين: محمد قبلة الدنيا وكعبتها. و: ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله
على أن اسم طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذه الألفاظ مخالفة للدين أم أنها من المباحات؟ علما أنها تنشد بدون دف. أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. متفق عليه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله. رواه البخاري.
قال ابن حجر: الْإِطْرَاء الْمَدْح بِالْبَاطِلِ، تَقُول: أَطْرَيْت فُلَانًا، مَدَحْته فَأَفْرَطْت فِي مَدْحه. اهـ.
ولما قال وفد بني عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
قال ابن الأثير في النهاية: أي لا يَسْتَغْلِبَنَّكم فيتَّخِذكم جَرِيًّا: أي رَسُولا ووكِيلاً. وذلك أنهم كانوا مَدَحُوه فكَرِه لهم المبالغَة في المدْح فنَهاهُم عنه.
وَفِي النِّهَايَة :أَيْ لَا يَغْلِبَنكُمْ فَيَتَّخِذكُمْ جَرْيًا أَيْ رَسُولًا وَوَكِيلًا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَدَحُوهُ فَكَرِهَ لَهُمْ الْمُبَالَغَة فِي الْمَدْح فَنَهَاهُمْ عَنْهُ. اهـ.
وقال السِّنْدِيُّ: أَيْ لَا يَسْتَعْمِلَنكُمْ الشَّيْطَان فِيمَا يُرِيد مِنْ التَّعْظِيم لِلْمَخْلُوقِ بِمِقْدَارِ لَا يَجُوز. اهـ.
فينبغي الحذر من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة المدح الذي يصل بالعبد لدرجة الشرك أو يكون ذريعة له.
ومقولة: محمد قبلة الدنيا وكعبتها. وإن كان يمكن أن يؤول معناها بحيث لا يكون فيها خطأ ولا انحراف، إلا أنها ينطبق عليها الحديث السابق: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
وأما مقولة: ودعوت بطه الله. فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 116496. أن هذه العبارة نوع من التوسل، والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحقه، أو جاهه، أو صفته، أو بركته، من أنواع التوسل الممنوعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو بدعة لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وفيها التنبيه على أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
تقييمى لكِ ياغالية
تسلم ايدك على تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير ما حييتى
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجمة الذهبية
السؤال
السؤال: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات:
يا سيدي يا رسول الله يا سندي ** يا واسع الفضل والإحسان والمدد
يا من هو المرتجى في كل نازلة ** ومن هو المورد الأحلى لكل صدِ
يمناك فوق البحار الزاخرات ندىً *** تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد
كم شدة أنت كافيها وكم محن *** حلت يمينك منها سائر العقد
يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي *** في القلب والجسم آلام تعاودني
إذا نظرت إليها اليوم لم تعـــــد *** أأشتكي الضيق والحرمان في بلد
فيها غياث البرايا منحة الصمد *** فيها الحبيب الذي ترجى شفاعته
ويستجار به في أعظم الشـــــــدد *** كل المطالب والحاجات إن فقدت
فإنها ترتجى في هذه البلد *** يا آخذاً بيد الملهوف هاك يدي
مبسوطة لسؤال العطف والمدد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعياذا بالله ثم عياذا به من هذا الكلام القبيح المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه الأبيات على شيء عظيم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه ووصفه بما هو مختص بالرب تبارك وتعالى من كونه المرتجى في النوازل والمؤمل في الشدائد، وأنه غياث البرايا ونحو ذلك من الأوصاف التي لا يستحق أن يوصف بها إلا الله وحده، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص والدين الحنيف النقي عن أدران الشرك، وحذر أمته من الغلو فيه أو في غيره صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ونهى أمته عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم مبينا لهم أنه عبد وأن يقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه الله تعالى حين دعا على بعض الناس بقوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ{آل عمران:128}.
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
تقييمى لكِ ياغالية
بارك الله فيكش على تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منة الله أشرف
ما هو حكم الشرع في جلسات مدح الرسول صلى الله عليه وسلم (الموالد)، ويذكر فيها على سبيل المثال: يا رسول الله يا مفرج الهم والكرب؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
***********************************************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه بالشعر والنثر، وفي الخطب والمواعظ والدروس كل ذلك جائز حسن، ما لم يشتمل ذلك على محظور شرعاً، ومن ذلك أن يشتمل المديح للنبي صلى الله عليه وسلم على وصف لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى كما جاء في سؤال السائل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " رواه البخاري .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في الفتاوى 1/96: فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى.
ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جويريات يقلن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) قال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " رواه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التوحيد: 1/71 وقد دل الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة. أما ما اعتاده الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ أو الأساتذة فتخطوا في ذلك حدود الشرع انتهى.
فالحاصل أن مدحه صلى الله عليه وسلم حسن، ما لم يشتمل على غلو أو كذب. قال الإمام الرحيباني في مطالب أولى النهى: (2/501) عن الشعر: ويباح إن كان حكما وأدباً ومواعظ وأمثالاً، أو لغة يستشهد بها على تأويل القرآن والحديث، أو مديحاً للنبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بما لا كذب فيه.
أما حكم الاحتفال بالموالد فقد تقدم الجواب عنه برقم: 1741 فراجعه.
والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات:
يا سيدي يا رسول الله يا سندي ** يا واسع الفضل والإحسان والمدد
يا من هو المرتجى في كل نازلة ** ومن هو المورد الأحلى لكل صدِ
يمناك فوق البحار الزاخرات ندىً *** تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد
كم شدة أنت كافيها وكم محن *** حلت يمينك منها سائر العقد
يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي *** في القلب والجسم آلام تعاودني
إذا نظرت إليها اليوم لم تعـــــد *** أأشتكي الضيق والحرمان في بلد
فيها غياث البرايا منحة الصمد *** فيها الحبيب الذي ترجى شفاعته
ويستجار به في أعظم الشـــــــدد *** كل المطالب والحاجات إن فقدت
فإنها ترتجى في هذه البلد *** يا آخذاً بيد الملهوف هاك يدي
مبسوطة لسؤال العطف والمدد.
***********************************************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعياذا بالله ثم عياذا به من هذا الكلام القبيح المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه الأبيات على شيء عظيم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه ووصفه بما هو مختص بالرب تبارك وتعالى من كونه المرتجى في النوازل والمؤمل في الشدائد، وأنه غياث البرايا ونحو ذلك من الأوصاف التي لا يستحق أن يوصف بها إلا الله وحده، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص والدين الحنيف النقي عن أدران الشرك، وحذر أمته من الغلو فيه أو في غيره صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ونهى أمته عن إطرائه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم مبينا لهم أنه عبد وأن يقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه الله تعالى حين دعا على بعض الناس بقوله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ{آل عمران:128}.
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
تقييمى لكِ ياغالية
الله يسعدك على تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
amira alzlam
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أمة الله
تقييمى لكِ ياغالية
ولا تنسي تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير @amira alzlam;

توقيع : amira alzlam
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات amira alzlam
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 1,106
- amira alzlam
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى amira alzlam
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amira alzlam

توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
Wa Fa
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه ...
نسبتاً لكثرت الجدل والاراء والفتاوي لغير المؤهلين لها ممن يدعو ذلك ونسبتاً لجهل الناس بامور دينهم وعدم الاطلاع علي اسرار الشريعة الغراء وددت ان أورد فتوي للاهل العلم الذين شهدت البيضاء لهم بذلك وهم علماء الازهر الشريف (لولا الازهر لساد الظلام) لدار الافتاء المصرية عن حكم ومشروعة المديح النبوي ...
الســؤال :
يقول كثيرون إن المدائح النبوية من البدعة التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأن منها -كقصيدة البردة- ما يشتمل على أبيات فيها غلو، فما مدى صحة هذا القول ؟
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد..، فقد ظهر المديح النبوي في أوائل العصر النبوي المبارك حيث كان الشعر من الأسلحة المقالية التي يستخدمها العرب حينئذ، بين الهجاء والثناء، فكان الشعراء من المشركين يهجونه صلى الله عليه وسلم، فكان المدح النبوي يرد على هذا الهجاء ومن هؤلاء الشعراء الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوه، وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت، فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسَّانَ: «اهْجُهُمْ - أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ»(1).
ومَدْحُ الأُمَّةِ للنبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ على مَحبَّتها له، هذه المحبَّة التي تُعَدُّ أصلا من أصول الإيمان، قال تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [التوبة:24]، وقال صلى الله عليه وسلم: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»(2). وقال أيضًا: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(3).
ومحبَّة النبي صلى الله عليه وسلم مَظهَر محبة الله سبحانه، فمن أحبَّ مَلِكًا أحب رسوله، ورسول الله حبيب رب العالمين، وهو الذي جاء لنا بالخير كله، وتحمَّل المتاعب من أجل إسلامنا، ودخولنا الجنة؛ وقد وصفه ربنا في مواضع كثيرة من القرآن بصفات تدل على فضله، منها قوله تعالى:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}[القلم: 4].
وقد عرَّف العلماء المديح النبوي بأنه هو الشِّعْرُ الذي ينصَبُّ على مدح النبي صلى الله عليه وسلم بتعداد صفاته الـخَلْقِيَّة والخُلُقِيَّة، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية، ونظم سيرته شعرًا، والإشادة بغزواته وصفاته الْمُثلى، والصلاة عليه تقديرًا وتعظيمًا، فهو شعر صادق بعيد عن التزلُّف والتكسُّب، ويرجى به التقرب إلى الله عز وجل، ومهما وصفه الواصفون، فلن يُوَفُّوه حقَّه صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الباجوري -رحمه الله - في مقدمة شرحه للبردة: إن كمالاته صلى الله عليه وسلم لا تُحْصَى، وشمائله لا تُسْتَقصى، فالمادحون لجنابه العلي والواصفون لكماله الجلي مقصِّرون عمَّا هنالك، قاصرون عن أداء ذلك، كيف وقد وصفه الله في كتبه بما يبهر العقول ولا يُسْتَطاع إليه الوصول، فلو بالغ الأوَّلون والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن ضبط ما حباه مولاه من مواهبه(4)، وقد أحسن من قال:
أَرى كلَّ مَدحٍ في النَبِيِّ مُقَصِّـرا وَلَو صيغَ فيه كُلُّ عِقدٍ مجوهَرا
وَهل يقدر المُدَّاحُ قَدرَ محمَّدٍ وَإِن بالَغ المثني عَلَيهِ وَأَكثَرا
إِذا اللَهُ أَثنى بِالَّذي هو أَهلُهُ عَلى مَن يَراهُ لِلمَحامِدِ مظهرا
وَخَصَّصهُ في رفعه الذكر مُثنيًا عَلَيهِ فَما مِقدار ما تمدح الوَرى
فكل علوٍّ في حقِّهِ صلى الله عليه وسلم تقصير، ولا يبلغ البليغ إلا قليلا من كثير.
ولم يقتصر مدحه صلى الله عليه وسلم بعد انتشار الإسلام وظهوره، بل إنه قد مُدِح أيضًا في الجاهلية، فقد مدحته أم معبد ووصفت أخلاقه وخُلُقه الكريم لزوجها بقولها: «مرَّ بنا رجل ظاهر الوضاءة، مليح الوجه، في أشفاره وطف، وفي عينيه دعج(5)، وفي صوته صحل(6)، غصن بين غصنين، لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه من قصر، لم تعلوه ثجلة(7)، ولم تزر به صعلة كأن عنقه إبريق فضة، إذا نطق فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، كلامه كخرز النظم، أزين أصحابه منظرًا، وأحسنهم وجهًا، محشود غير مفند، له أصحاب يحفون به، إذا أمر تبادروا أمره، وإذا نهى انتهوا عند نهيه، قال: هذه صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته، ولأجهدن أن أفعل»(9).
وقد مدحه أيضا بعض شعراء الكفار، مثل الأعشى حيث يقول في مدحه صلى الله عليه وسلم:
نَبِيٌّ يَرى ما لا تَرَونَ وَذِكرُهُ أَغارَ لَعَمري في البِلادِ وَأَنجَدا
لَهُ صَدَقاتٌ ما تُغِبُّ وَنائِلٌ وَلَيسَ عَطاءُ اليَومِ مانِعَهُ غَدا
وقال بعض الباحثين: إن شعر المديح النبوي فنٌّ مستحدثٌ لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع البوصيري وابن دقيق العيد، والحق أن المديح النبوي ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على يد حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير، وعبدالله بن رواحة، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن كعب بن زهير بن أبي سلمى أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قصيدته المشهورة التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي مطلعها:
بانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ مُتَيَّمٌ إِثرَها لَم يُـفَـدْ مَكبولُ
ويقول فيها:
أُنبِئتُ أَنَّ رَسولَ اللَهِ أَوعَدَني وَالعَفُوُ عِندَ رَسولِ اللَهِ مَأمولُ
مَهلًا هَداكَ الَّذي أَعطاكَ نافِلَةَ الـ ـقُرآنِ فيها مَواعيظٌ وَتَفصيلُ
لا تَأَخُذَني بِأَقوالِ الوُشاةِ وَلَم أُذِنب وَلَو كَثُرَت عَنِّي الأَقاويلُ
ثم ظل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القصيدة، ومن الأبيات التي يمدحه بها قوله:
إِنَّ الرَسولَ لَنورٌ يُستَضاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللَهِ مَسلولُ
فأقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم مدح كعب بن زهير له ولم ينهه عن مدحه ولا على إنشاده في المسجد، بل كساه بردة.
وروى خُرَيْم بن أوس بن حارثة بن لام قال: كُنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العباس بن عبد المطلب رحمه الله: يا رسول الله إني أريد أن أمدحك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هَاتِ لا يَفْضُضِ اللَّهُ فَاكَ»(10)، فأنشأ العباس يقول شعرًا منه قوله:
وَأَنتَ لَمَّا وُلِدتَ أَشرَقَتِ الــ أَرضُ وَضاءَت بِنورِكَ الأُفُقُ
فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبْلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ
فنجد أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ عمَّه أن يمدحه ولم يعترض عليه، فهذا دليل على مشروعية مدحه صلى الله عليه وسلم.
- مشاركات Wa Fa
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 560
Wa Fa
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
وتُعدُّ قصيدة [الكواكب الدرية في مدح خير البرية]، والمعروفة باسم [البردة] من عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام، الذي جادت به قرائح الشعراء على مرِّ العصور، وقد أجمع معظم الباحثين على أنها أفضل قصيدة في المديح النبوي إذا استثنينا لامية كعب بن مالك (البردة الأم)، حتى قيل: إنها أشهر قصيدة في الشعر العربي بين العامة والخاصة. وقد ذكر الشاعر في هذه القصيدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وتكلَّم على معجزاته وخصائصه.
وقد وجَّه البعض انتقادات كثيرة، يرمون فيها قصيدة البردة وغيرها من قصائد المديح النبوي بالغلو، ولكننا نقول: إن الأصل في الألفاظ التي تجري على ألسنة الموحدين أن تُحمَل على المعاني التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا ينبغي أن نبادر برمي الناس بالكفر والفسق والضلال والابتداع، فإن إسلامه قرينة قويَّة توجب علينا ألا نحمل ألفاظه على معناها الظاهر إن اقتضت كُفْرًا أو فِسْقًا، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل العبارات التي يسمعونها من إخوانهم المسلمين.
ولنضرب مثلا للأبيات التي اتُهِمَت بالغلو، ثم نوضح المعنى الصحيح التي تُحْمَل عليه، من هذه الأبيات قوله:
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ والثَّقَلَيْنِ والفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمِ
فنجد أن المعنى المقصود من هذا البيت هو بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الدنيا والآخرة، وسيد الإنس والجن، وسيد العرب والعجم، ولا خلاف في هذا بين عامَّة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(14).
وقوله:
يا أكْرَمَ الرُّسْلِ ما لِي مَنْ أَلوذُ به سِواكَ عندَ حلولِ الحادِثِ العَمِمِ
فالشاعر يقصد بالحادث العمم هنا هو يوم القيامة، وأن الناس كلهم يتجهون إلى الأنبياء لطلب الشفاعة، كما ورد في الحديث: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك- وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك – فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله -قال - فيأتون نوحًا صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست هناكم -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذى اتخذه الله خليلا . فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست هناكم - ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلَّمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى -عليه السلام - فيقول لست هناكم -ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها- ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ – قَالَ: فَلاَ أَدْرِى فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ،قَالَ: فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ»(15).
فيتضح لنا بعد قراءة قصائد ودواوين المديح النبوي عبر تعاقبه التاريخي والفني أنه كان يستوحي مادته الإبداعية ورؤيته الإسلامية من القرآن الكريم أولًا، فالسنة النبوية الشريفة ثانيًا، اعتمادًا على الكتب المعتمدة في السيرة النبوية، مثل [السيرة النبوية لابن هشام]، و[السيرة النبوية لابن حبان]، و[الوفاء بأحوال المصطفى] لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، و[الشفا بتعريف حقوق المصطفى] للقاضي عياض، وغيرها.
وعلى هذا فمدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وإنشاده في المسجد له فضلٌ كبيرٌ، وأن الأبيات التي اتُهِمَت بالغلو عند مراجعتها ومراجعة شروحها نجد أنها تُهَمٌ باطلةٌ، إذا فُهِمَ المقصود منها على أساس إحسان الظن، والله تعالى أعلى وأعلم.
----------------------------
2- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير – دمشق.
3- فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة – بيروت.
4- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار إحياء التراث – القاهرة.
5- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة.
6- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر – بيروت.
---------------------------
(2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم (14).
(3) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (178)، النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، حديث رقم (5030)، ابن ماجه، المقدمة، حديث رقم (70).
(4) شرح الباجوري على البردة ص 5، 6.
(5) يقال: «دَعِجَت العين دَعَجًا»: اشتد سوادها وبياضها واتَّسعت، فهي دعجاء.
(6) يقال: صحل فلان: كان في صوته بُحَّة.
(7) ثَجِل فلان: عظُمَ بطنه واسترخى.
(8) الصَّعْلَةُ: الدِّقة والنحول والخفة في البدن.
(9) المعجم الكبير للطبراني 7/105.
(10) المعجم الكبير للطبراني 2/213.
(11) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم (3484).
(12) فتح الباري لابن حجر 6/490.
(14) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم (3375)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (502).
(15) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (495).
- مشاركات Wa Fa
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 560
بياض الثلج
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
تم التقيي? [MENTION=87979]أم أمة الله[/MENTION];
هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد؟ وبتخصيص ليلة الجمعة وليلة الاثنين؟ وإن كان هذا يباح فما هو الثواب؟ وإن كان لا يجوز فما هو المدح الذي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، أم لا يجوز إطلاقاً؟ أرشدونا وفقكم الله إلى ما فيه الخير والبركة.
الجواب:
الشيخ: مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخصال الحميدة والمناقب العظيمة والأخلاق الكاملة هذا أمر مشروع ومحمود لما فيه من الدعوة إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته، وكل هذا من الأمور المقصودة شرعاً. وأما مدحه بالغلو الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز بكل حال، كما لو مدحه بقول القائل:
إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
فإن مثل هذا الغلو لا يجوز، وهو محرم. وعلى الوجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة أو في يوم معين من حيث كلما أتت هذه الليلة وهذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح، فإن تخصيص الشيء بالزمن لم يخصص به الشرع أو بمكان لم يخصص به الشرع من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
https://binothaimeen.net/content/7238#
مقطع صوتى
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
توقيع : بياض الثلج
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات بياض الثلج
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 4,999
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wa fa
وتُعدُّ قصيدة [الكواكب الدرية في مدح خير البرية]، والمعروفة باسم [البردة] من عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام، الذي جادت به قرائح الشعراء على مرِّ العصور، وقد أجمع معظم الباحثين على أنها أفضل قصيدة في المديح النبوي إذا استثنينا لامية كعب بن مالك (البردة الأم)، حتى قيل: إنها أشهر قصيدة في الشعر العربي بين العامة والخاصة. وقد ذكر الشاعر في هذه القصيدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وتكلَّم على معجزاته وخصائصه.
وقد وجَّه البعض انتقادات كثيرة، يرمون فيها قصيدة البردة وغيرها من قصائد المديح النبوي بالغلو، ولكننا نقول: إن الأصل في الألفاظ التي تجري على ألسنة الموحدين أن تُحمَل على المعاني التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا ينبغي أن نبادر برمي الناس بالكفر والفسق والضلال والابتداع، فإن إسلامه قرينة قويَّة توجب علينا ألا نحمل ألفاظه على معناها الظاهر إن اقتضت كُفْرًا أو فِسْقًا، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل العبارات التي يسمعونها من إخوانهم المسلمين.
ولنضرب مثلا للأبيات التي اتُهِمَت بالغلو، ثم نوضح المعنى الصحيح التي تُحْمَل عليه، من هذه الأبيات قوله:
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ والثَّقَلَيْنِ والفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمِ
فنجد أن المعنى المقصود من هذا البيت هو بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الدنيا والآخرة، وسيد الإنس والجن، وسيد العرب والعجم، ولا خلاف في هذا بين عامَّة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(14).
وقوله:
يا أكْرَمَ الرُّسْلِ ما لِي مَنْ أَلوذُ به سِواكَ عندَ حلولِ الحادِثِ العَمِمِ
فالشاعر يقصد بالحادث العمم هنا هو يوم القيامة، وأن الناس كلهم يتجهون إلى الأنبياء لطلب الشفاعة، كما ورد في الحديث: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك- وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك – فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله -قال - فيأتون نوحًا صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست هناكم -فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذى اتخذه الله خليلا . فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست هناكم - ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها - ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلَّمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى -عليه السلام - فيقول لست هناكم -ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها- ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ – قَالَ: فَلاَ أَدْرِى فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ،قَالَ: فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ»(15).
فيتضح لنا بعد قراءة قصائد ودواوين المديح النبوي عبر تعاقبه التاريخي والفني أنه كان يستوحي مادته الإبداعية ورؤيته الإسلامية من القرآن الكريم أولًا، فالسنة النبوية الشريفة ثانيًا، اعتمادًا على الكتب المعتمدة في السيرة النبوية، مثل [السيرة النبوية لابن هشام]، و[السيرة النبوية لابن حبان]، و[الوفاء بأحوال المصطفى] لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، و[الشفا بتعريف حقوق المصطفى] للقاضي عياض، وغيرها.
وعلى هذا فمدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وإنشاده في المسجد له فضلٌ كبيرٌ، وأن الأبيات التي اتُهِمَت بالغلو عند مراجعتها ومراجعة شروحها نجد أنها تُهَمٌ باطلةٌ، إذا فُهِمَ المقصود منها على أساس إحسان الظن، والله تعالى أعلى وأعلم.
----------------------------
2- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير – دمشق.
3- فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة – بيروت.
4- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار إحياء التراث – القاهرة.
5- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة.
6- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر – بيروت.
---------------------------
(2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث رقم (14).
(3) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (178)، النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، حديث رقم (5030)، ابن ماجه، المقدمة، حديث رقم (70).
(4) شرح الباجوري على البردة ص 5، 6.
(5) يقال: «دَعِجَت العين دَعَجًا»: اشتد سوادها وبياضها واتَّسعت، فهي دعجاء.
(6) يقال: صحل فلان: كان في صوته بُحَّة.
(7) ثَجِل فلان: عظُمَ بطنه واسترخى.
(8) الصَّعْلَةُ: الدِّقة والنحول والخفة في البدن.
(9) المعجم الكبير للطبراني 7/105.
(10) المعجم الكبير للطبراني 2/213.
(11) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم (3484).
(12) فتح الباري لابن حجر 6/490.
(14) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم (3375)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (502).
(15) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم (495).
تقييمى لكِ ياغالية
ولا تنسي تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
حياه الروح 5
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
توقيع : حياه الروح 5
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات حياه الروح 5
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 85,489
- حياه الروح 5
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى حياه الروح 5
Wa Fa
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أمة الله
تقييمى لكِ ياغالية
ولا تنسي تقييم اخواتك فى المسابقة ربنا يجعلك فى الخير

تم تقييــم الكل

- مشاركات Wa Fa
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 560
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wa fa

تم تقييــم الكل

توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
Wa Fa
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أمة الله

- مشاركات Wa Fa
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 560
وغارت الحوراء
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
حكم الغلو في مدح الرسول
@أم أمة الله; جزاكِ الله خيرا ، تم تقيم الجميع.
توقيع : وغارت الحوراء
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات وغارت الحوراء
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 11,514
- وغارت الحوراء
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى وغارت الحوراء
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وغارت الحوراء
حكم الغلو في مدح الرسول
@أم أمة الله; جزاكِ الله خيرا ، تم تقيم الجميع.
شكر الله لكِ تشجيعك لاخواتك فى ميزان حسناتك يارب
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وغارت الحوراء
حكم الغلو في مدح الرسول
@أم أمة الله; جزاكِ الله خيرا ، تم تقيم الجميع.
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
ಇESRAAಇ
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
توقيع : ಇESRAAಇ
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات ಇESRAAಇ
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 2,568
أم أمة الله
 رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
رد: المسابقة اليومية للمجتهدين ربنا يرضى عليكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ಇesraaಇ
وعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى ـ قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وفي الصحيح عن أنس قال: شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شَجُّوا نبيهم؟ فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ { آل عمران: 47}.
وفيه عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (47) الآية.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
وفيه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ـ قال: يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً.
والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فليحرص على اتباعه فإن ذلك دليل محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم { آل عمران: 31}.
ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم حماية ما حماه من جناب التوحيد ونبذ الغلو وترك الإفراط في المدح الذي قد يجر إلى الشرك ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فلا يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات المذكورة لما اشتملت عليه من المعاني المنافية لما بعث به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
تسلم اديكِ على التقييم لاخواتك الله يجعلك فى الخير ما حييتى
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
- مشاركات أم أمة الله
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 21,568
- أم أمة الله
- مشاهدة ملفه الشخصي
- إرسال رسالة خاصة إلى أم أمة الله
 قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ادعية مرتبة حسب ترتيب القرآن الكريم | لحظة حنين | المنتدي الاسلامي العام | 8 | 06-02-2019 06:21 PM |
| ((تكريم .((الأخت الفائزة ))فى المسابقة اليومية المتجددة | أم أمة الله | مسابقات الاقسام | 7 | 11-03-2017 03:44 PM |
| ((تكريم .((الأخت الفائزة ))فى المسابقة اليومية المتجددة | أم أمة الله | مسابقات الاقسام | 15 | 03-03-2017 11:19 PM |
| سؤال اليوم الخميس من المسابقة اليومية المتجددة | أم أمة الله | مسابقات الاقسام | 15 | 28-01-2017 05:07 PM |
| ادعية من القران | ام نونا | المنتدي الاسلامي العام | 10 | 13-02-2012 03:45 PM |
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع