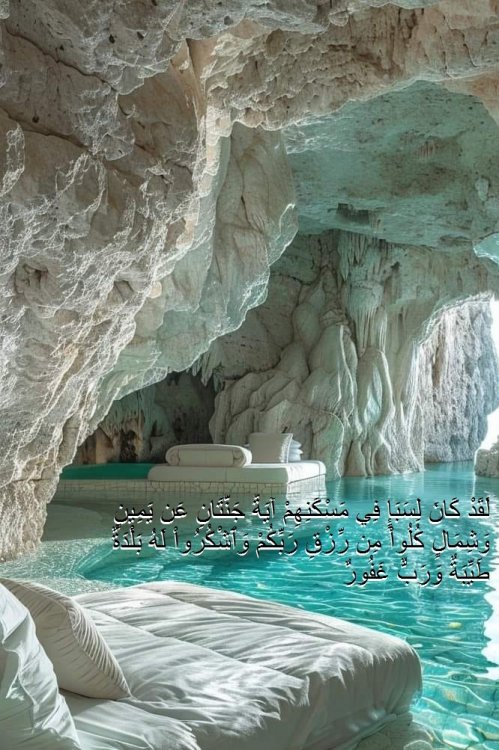#1
امانى يسرى
عضوة برونزية
بيانات العضوة
- رقم العضوية : 129663
- تاريخ التسجيل: 123Jul 2017
- الدولة : مصر
- المدينة : القاهرة
- الحالة الاجتماعية : غير متزوجة
- الوظيفة : مهندسه لأ اعمل
- المشاركات: 3,807 [+]
- الأصدقاء : 27
- نقاط التقييم : 402
 عاقبة كفران النعم (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ )
عاقبة كفران النعم (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ )
قصة سبأ
تفسير سورة سبأ للشيخ الشعراوي
21-15
(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)١٥-سبأ
ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - من قصة سليمان عليه السلام إلى أهل سبأ، فما العلاقة بينهما؟
المتأمل في سور القرآن وآياته يجد بينها ترابطاً وانسجاماً، والمناسبة هنا أن سيدنا سليمان كانت له أبرز قصة في الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ، فبينهما إذن علاقة، وهذه النقلة لها مناسبتها.
وقصة سليمان والهدهد وبلقيس قصة مشهورة، وبها دلالات إيمانية عظيمة في العقيدة، وفي بيان أن الحيوان عنده دراية بالعقيدة، وبأسرار الله في كونه.
وقصة سليمان والهدهد وبلقيس قصة مشهورة، وبها دلالات إيمانية عظيمة في العقيدة، وفي بيان أن الحيوان عنده دراية بالعقيدة، وبأسرار الله في كونه.
و (سَبَأ) عَلَم على رجل اسمه عمرو بن عامر، ويُلقِّبونه بمزيقباء وأبوه (ماء السماء) وقد سأل كرَّة بين نسيك رضي الله عنه سيدنا رسول الله عن سبأ فقال: (كذا وكذا ...) وكان له عشرة أولاد هم: أزد، وكِنْدة، ومَذْحج، وأشعريون، وأنمار، وغسان، وعاملة، ولَخْم، وجُذَام، وخثعم.
إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأي قالت لسبأ هذا: إن السد سيخرب ويُغْرق ماؤه اليمن فاخرج منها، وفعلاً خرج سبأ إلى الحجاز والشام، حيث ذهب الغساسنة إلى الشام، والمناذرة إلى العراق، وأنمار إلى المدينة، وأزد إلى عمان في الأردن.
واسم سبأ بعد أنْ كان عَلَماً على شخص تعدَّى إلى أنْ صار اسماً لقبيلة، ثم اسماً للمكان الذي يسكنونه.
وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ .. } [سبأ: 15] أي: المكان الذي يسكنونه، والمكان الذي يعيش فيه الإنسان يُسمَّى (سكن) أو (بيت) أو (منزل)، ولكل منها معنى. والسكن هو المكان الذي يتخذه الإنسان ليسكن إليه وليطمئن فيه، ويرتاح من حركة الحياة والعمل، والإنسان لا يسكن إلا في مكان تتوفر فيه مُقوِّمات الحياة والأمن.
لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند البيت دعا ربه: { { رَّبَّنَآ إِنَّيۤ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ .. } [إبراهيم: 37].
فقد كان هذا المكان جَدْباً لا زرع فيه ولا ماء، ولا مُقوِّم من مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى { { أَسْكَنتُ .. } [إبراهيم: 37] أي: وطَّنْتهم في هذا المكان.
لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وولده عند البيت دعا ربه: { { رَّبَّنَآ إِنَّيۤ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ .. } [إبراهيم: 37].
فقد كان هذا المكان جَدْباً لا زرع فيه ولا ماء، ولا مُقوِّم من مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى { { أَسْكَنتُ .. } [إبراهيم: 37] أي: وطَّنْتهم في هذا المكان.
أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أو عدة مرات، ثم ترحل عنه لا تقيم فيه إقامة دائمة، فهو كالاستراحات التي تُجعل للطوارئ، ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام في السنة كلها.
ومن ذلك ما "رُوِى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل ببدر سأله الصحابي الجليل الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ أن هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال: إذن لا أراه لك بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نُعَوِّر (نفسد) ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي" .
إذن: السكن فيه دوام واستقرار، أما المنزل فهو استراحة، إنْ شئتَ نزلتَ به، وإنْ شئتَ رحلتَ عنه.
أما البيت فيُلاحظ فيه البيتوتة، والإنسان لا ينام نوماً مريحاً إلا في مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله،
أما البيت فيُلاحظ فيه البيتوتة، والإنسان لا ينام نوماً مريحاً إلا في مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله،
فإن الخائف وكذلك الجوعان لا ينام.
ومن السكن قوله تعالى في بني إسرائيل: { { وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً } [الإسراء: 104].
ومن السكن قوله تعالى في بني إسرائيل: { { وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً } [الإسراء: 104].
أخذ أحد المستشرقين هذه الآية، وجعلها دليلاً على أن الأرض كلها مُبَاحة لليهود، كيف وهم في الأرض،
وأنت حين تريد هذا الأمر تقول: اسكن القاهرة، اسكن طنطا مثلاً، فتعين لي مكاناً، لكن { ٱسْكُنُواْ ٱلأَرْضَ } [الإسراء: 104] لها معنى آخر، هو التقطيع الذي قال الله عنه: { { وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أُمَماً .. } [الأعراف: 168].
يعني: ليس لهم وطن مخصوص، وسوف ينساحون في الدنيا كلها، ولن يتمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم، وهم على هذه الحالة من التقطيع، حتى يأتي أمر الله، ويجمعهم في مكان واحد، وعندها سيسهل القضاء عليهم.
يعني: ليس لهم وطن مخصوص، وسوف ينساحون في الدنيا كلها، ولن يتمكن أحد من ضربهم والقضاء عليهم، وهم على هذه الحالة من التقطيع، حتى يأتي أمر الله، ويجمعهم في مكان واحد، وعندها سيسهل القضاء عليهم.
ومعنى كلمة { آيَةٌ .. } [سبأ: 15] نقول: فلان آية في الكرم، وفلان آية في الأدب .. إلخ، والمراد شيء عجيب نادر الوجود،
والحق سبحانه حدثنا عن أنواع ثلاثة من الآيات:
آيات كونية مثل: { { وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلَّيلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ.. } [فصلت: 37] { { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .. } [فصلت: 39].
وآيات بمعنى معجزات وخوارق للعادة، تأتي على أيدي الرسل لتؤيدهم وتثبت صدْقهم في البلاغ عن الله، كما في قوله تعالى: { { ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ .. } [القصص: 32].
ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله في القرآن الكريم، وهذه كلها - سواء كانت آيات كونية، أو معجزات، أو آيات القرآن - كلها عجائب، وإن كانت هذه العجائب واضحة في الآيات الكونية وفي المعجزات، فهي أيضاً واضحة في آيات الكتاب الحكيم، فالقرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيُضطر إلى الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه، لا على أنها دين، ولكن على أنها قوانين حياة.
وآيات بمعنى معجزات وخوارق للعادة، تأتي على أيدي الرسل لتؤيدهم وتثبت صدْقهم في البلاغ عن الله، كما في قوله تعالى: { { ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ .. } [القصص: 32].
ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله في القرآن الكريم، وهذه كلها - سواء كانت آيات كونية، أو معجزات، أو آيات القرآن - كلها عجائب، وإن كانت هذه العجائب واضحة في الآيات الكونية وفي المعجزات، فهي أيضاً واضحة في آيات الكتاب الحكيم، فالقرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيُضطر إلى الأخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه، لا على أنها دين، ولكن على أنها قوانين حياة.
وسبق أنْ مثَّلْنا لذلك بأحكام الطلاق التي طالما نقدوها وهاجموها، واتهموا دين الله - ظلماً وجهلاً - بالقسوة، ثم بعد ذلك نراهم يلجئون إليه، ولا يجدون حلاً لبعض مشكلاتهم إلا في الطلاق وفي الرجوع إلى أحكام الله، مع أنهم غير مؤمنين به، وهذا منتهى الغَلَبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به، إنها غلبة الحق وغلبة الحجة.
وسبق أنْ قُلْنا: إن أحد المستشرقين سألنا في سان فرانسيسكو قال: في القرآن { { هُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ } [الصف: 9].
وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان ما زال في الدنيا يهودية ومسيحية وبوذية ... إلخ، وهذا الكلام يدل على عدم فَهْم لمعنى الآيات، فليس المراد { { لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ .. } [الصف: 9] أن يصبح الناس جميعاً مؤمنين، بدليل قوله تعالى { { وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ .. } [الصف: 9].
إذن: فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم، وسوف يطرأ عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدون له حلاً إلا في شرع الله، وهذا هو الظهور المراد في الآية.
ثم يوضح الحق - تبارك وتعالى - ماهية الآية التي كانت لسبأ في مسكنهم، فيقول سبحانه: { جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. } [سبأ: 15] وما دام الله تعالى وصف هاتين الجنتين بأنهما آية، فلا بُدَّ أن فيهما عجائب، وأنهما يختلفان عن الجِنَان التي نعرفها.
وقد حدَّثنا العلماء عن هذه العجائب فقالوا عن هاتين الجنتين: لا تجد فيهما عقرباً، ولا حية، ولا ذباباً، ولا برغوثاً ... إلخ، فإنْ طرأ عليهما طارئ، وفي جسمه قُمَّل فإنه يموت بمجرد أنْ يدخل إحدى هاتين الجنتين، وهذه كلها عجائب في الجنتين.
ونلاحظ هنا أن الآية مفرد والعجائب كثيرة؛ لأن كلمة آية تُطْلَق على الجمع أيضاً، ومن ذلك قوله تعالى في سيدنا عيسى عليه السلام: { { وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. } [المؤمنون: 50] ولم يقل آيتين، قالوا: لأن الأمر العجيب الذي جمعهما واحد، فعيسى عليه السلام وُلِد من لا ذكورة، وأمه حملتْ وولَدتْ كذلك من لا ذكورة، فالآيتان آية واحدة.
ومعنى: { جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. } [سبأ: 15] يحتمل أنْ يكون لكل واحد منهم جنتان، واحدة عن اليمين، والأخرى عن الشمال، وبيته في الوسط، ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جميعاً، بمعنى أنها جِنَان موصولة عن اليمين، وجِنَان موصولة عن الشمال وَصْلاً لا يُميَّز بسور ولا حائط، مما يدل على أن الأمن كان مستتباً بينهم، وقد شاهدنا مثل هذا في أمريكا، حيث الحقول والمزارع ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سِلْك بسيط.
ومعنى: { جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. } [سبأ: 15] يحتمل أنْ يكون لكل واحد منهم جنتان، واحدة عن اليمين، والأخرى عن الشمال، وبيته في الوسط، ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جميعاً، بمعنى أنها جِنَان موصولة عن اليمين، وجِنَان موصولة عن الشمال وَصْلاً لا يُميَّز بسور ولا حائط، مما يدل على أن الأمن كان مستتباً بينهم، وقد شاهدنا مثل هذا في أمريكا، حيث الحقول والمزارع ممتدة متصلة لا يفصلها إلا مجرد سِلْك بسيط.
وقوله سبحانه { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ .. } [سبأ: 15] كيف نفهم { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ .. } [سبأ: 15] والناس جميعاً يأكلون من رزق الله؟ قالوا: الناس يأكلون من رزق الله بالأسباب، إنما هذا رزق الله مباشرة بلا أسباب؛ لذلك يقول تعالى في موضع آخر { { كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. } [طه: 81].
فليس كل الرزق طيباً للأكل، إنما هنا { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ .. } [سبأ: 15] أي: كله طيب، وكله حلو، فالفاكهة في هاتين الجنتين لا يصيبها عطب، ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فساد؛ لذلك سيقول سبحانه في آخر الآية: { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } [سبأ: 15].
فليس كل الرزق طيباً للأكل، إنما هنا { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ .. } [سبأ: 15] أي: كله طيب، وكله حلو، فالفاكهة في هاتين الجنتين لا يصيبها عطب، ولا يطرأ على ثمارها ما يطرأ على الثمار من فساد؛ لذلك سيقول سبحانه في آخر الآية: { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } [سبأ: 15].
ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة؛ لذلك نرى الفلاح حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجأ إلى زراعة الحدائق والبساتين المثمرة؛ لأنها أقلّ تكلفة، ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا وقت الإثمار.
والحق سبحانه يقول في غير هذا الموضع: { { أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ } [الواقعة: 63-64] فأثبت لهم عملاً وحرثاً، إنما المسألة هنا في هاتين الجنتين، فهي عطاء من الله بلا عمل وبلا أسباب، فالله سبحانه هو الزارع، وقد خصَّها بالجو اللطيف، لا حرَّ ولا قرَّ، ولا سآمة، ولا مخافة، ولا زهد في نعمة من النعم لتكرارها.
والحق سبحانه يقول في غير هذا الموضع: { { أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ } [الواقعة: 63-64] فأثبت لهم عملاً وحرثاً، إنما المسألة هنا في هاتين الجنتين، فهي عطاء من الله بلا عمل وبلا أسباب، فالله سبحانه هو الزارع، وقد خصَّها بالجو اللطيف، لا حرَّ ولا قرَّ، ولا سآمة، ولا مخافة، ولا زهد في نعمة من النعم لتكرارها.
إذن لا عمل لهم في حدائقهم ينتج ما يستمتعون به، إنما عملهم أنْ يشكروا المُنعِمَ سبحانه ليزيدهم من الخيرات، وشكْر النعمة هو حكمة العبد مع مولاه؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان: { { وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ .. } [لقمان: 12] ما هذه الحكمة؟ { { أَنِ ٱشْكُرْ للَّهِ.. } [لقمان: 12] لأن شكر النعمة يزيدها.
وقوله سبحانه: { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ .. } [سبأ: 15] يعني: تعطيك طيب الأشياء بدون منغصات فيها؛ لأن هناك أشياء تعطيك طيباً تهنأ به، لكنها تتعبك وتنغِّصك فيما بعد.
أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئاً مريئاً؛ لأنها رزق الله بدون أسباب من العباد، لكن حين يتدخل العباد في عطاء الله تظهر في النعم متاعب ومنغِّصات، وهذا ما نعاني منه الآن بسبب التدخل في المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية، التي أفسدت علينا حياتنا، وجاء ضررها أكثر من نفعها حتى أصبحنا نعزو كل الأمراض إلى تدخّلنا في عطاء الله، ولو تركنا الأرض تُروى بماء السماء كما كان في البداية لذُقْنا الخير بلا مُنغِّصات، فمن الضروري أن نتأدب مع الله في عطائه.
أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئاً مريئاً؛ لأنها رزق الله بدون أسباب من العباد، لكن حين يتدخل العباد في عطاء الله تظهر في النعم متاعب ومنغِّصات، وهذا ما نعاني منه الآن بسبب التدخل في المزروعات بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية، التي أفسدت علينا حياتنا، وجاء ضررها أكثر من نفعها حتى أصبحنا نعزو كل الأمراض إلى تدخّلنا في عطاء الله، ولو تركنا الأرض تُروى بماء السماء كما كان في البداية لذُقْنا الخير بلا مُنغِّصات، فمن الضروري أن نتأدب مع الله في عطائه.
لذلك تجد كثيراً من المترفين والمثقفين وأهل العلم والفلاسفة يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها من صخب ويخرجون إلى الريف أو البراري، يهربون من الآثار الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء، حيث يعيش راعي الأغنام، حيث الطبيعة كما خلقها الله، وحيث الفطرة السليمة التي لم يتدخل فيها البشر.
تذكرون في الماضى، كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية طبيعية، فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة (دى دى تي) للقضاء على دودة القطن، لكن هذه المادة السامة أماتتْ كل شيء في الحقول، قضَتْ على الأسماك في الترع والمصارف، وقضتْ على (أبى قردان) صديق الفلاح، ولوَّثت الماء والمزروعات ... إلخ. أما دودة القطن فهي الوحيدة التي أخذت مناعة، وأصبحت كما قلنا (كييفة) دى دى تي.
أما سبأ فكانت { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ .. } [سبأ: 15] بكل ما فيها من طيب الماء والهواء والتربة لم يُصِبْها تلوث من أىِّ نوع، وإذا كانت البلدة نفسها طيبة، فما بالك بما عليها؟
تذكرون في الماضى، كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدوية طبيعية، فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة (دى دى تي) للقضاء على دودة القطن، لكن هذه المادة السامة أماتتْ كل شيء في الحقول، قضَتْ على الأسماك في الترع والمصارف، وقضتْ على (أبى قردان) صديق الفلاح، ولوَّثت الماء والمزروعات ... إلخ. أما دودة القطن فهي الوحيدة التي أخذت مناعة، وأصبحت كما قلنا (كييفة) دى دى تي.
أما سبأ فكانت { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ .. } [سبأ: 15] بكل ما فيها من طيب الماء والهواء والتربة لم يُصِبْها تلوث من أىِّ نوع، وإذا كانت البلدة نفسها طيبة، فما بالك بما عليها؟
وفى الآية طلبان { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ .. } [سبأ: 15] وفيها تحذير: إياك أنْ تغتر بالنعمة، وتظن أنها أصبحت ملكاً لك، وتنسى المنعم بها عليك، إياك أنْ تكون كالذي قال الله فيه { { كَلاَّ إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ ٱسْتَغْنَىٰ } [العلق: 6-7].
إياك أن تظن أنك أصيل في هذه المسألة، وظلّ دائماً على ذِكْر بأن المنعم هو الله، وأن ما أنت فيه هو من عطاء الله، ثم بعد ذَلك عليك أن تشكره سبحانه؛ لأن الشكر قيد النعم.
وفي موضع آخر، تكلم الحق سبحانه عن شكر النعمة فقال: { { وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ } [سبأ: 13] والحمد لله أنه سبحانه لم يقُلْ: وقليل من عبادي الشاكر، وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من الشكر، أو الشكور هو الذي يشكر على النعمة، ثم يشكر الله على أن ألهمه أنْ يشكر على النعمة، فكأنه قدَّم الشكر مرتين.
إياك أن تظن أنك أصيل في هذه المسألة، وظلّ دائماً على ذِكْر بأن المنعم هو الله، وأن ما أنت فيه هو من عطاء الله، ثم بعد ذَلك عليك أن تشكره سبحانه؛ لأن الشكر قيد النعم.
وفي موضع آخر، تكلم الحق سبحانه عن شكر النعمة فقال: { { وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ } [سبأ: 13] والحمد لله أنه سبحانه لم يقُلْ: وقليل من عبادي الشاكر، وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من الشكر، أو الشكور هو الذي يشكر على النعمة، ثم يشكر الله على أن ألهمه أنْ يشكر على النعمة، فكأنه قدَّم الشكر مرتين.
ثم لم يَقْصُر النعمة على أهل سبأ في الدنيا وحَسْب، إنما تعدَّت نعمته عليهم إلى الآخرة، ففى الدنيا { بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ .. } [سبأ: 15] وفي الآخرة { وَرَبٌّ غَفُورٌ } [سبأ: 15] يعني: يتجاوز عنكم إنْ حدثت منكم زَلَّة أو هفوة.
ثم يُبيِّن الحق سبحانه النتيجة وردَّ فِعْلهم
(فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ١٦ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجَٰزِيۤ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ)١٧
{ فَأَعْرَضُواْ .. } [سبأ: 16] أي: عن المأمور به، وهو { { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ .. } [سبأ: 15] فلم يأكلوا من رزق الله، إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم - على حدِّ زعمهم - وهذه أول الخيبة، ثم لم يشكروا الله على هذه النعم؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا شكرها.
وفَرْق بين ترف وأترف، نقول: ترف فلان أن تنعَّم. لكن أترف فلان، أي: غرَّته النعمة؛ لذلك قال تعالى: { { وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا .. } [الإسراء: 16].
فلا بأس أنْ تتنعم، لكن المصيبة أن تُطغيك النعمة، وتغرّك، وأول طغيان بالنعمة أن تنسبها إلى نفسك فتقول: بمجهودي وشطارتي كالذي قال: { { إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيۤ .. } [القصص: 78] ثم أنْ تنسى المنعِم، فلا تشكره على النعمة.
وفي موضع آخر لخَّص لنا الحق سبحانه هذه القضية في قوله سبحانه { { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } [النحل: 112].
وقال في قوم سيدنا نوح عليه السلام: { { وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقاً } [الجن: 16].
إذن: صيانة النعمة بشكرها والاعتراف بها كلها منسوبة إلى المنعِم سبحانه، وحتى نحن على مستوى البشر نقول: فلان هذا حافظ للجميل، فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر، فما بالك بالحق سبحانه وتعالى؟!
وكلمة الإعراض تُعطِي شيئاً فوق الإهمال وفوق النسيان؛ لأن الإعراض أنْ تنصرف عن مُحدِّثك وتعطيه جانبك كما تقول لمَنْ لا يعجبك حديثه (اعطني عرض كتافك).
إذن: الإعراض تَرْك متعمَّد بلا مبالاة، أما السهو أو النسيان أو الخطأ أو عند النوم، فهذه كلها أمور مُعْفىً عنها، قد رفعها الله عنَّا رحمة بنا، فربُّك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل.
واقرأ إنْ شئتَ قول ربك: { { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ } [طه: 124].
لماذا؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر، فالنكبة فيه أشدُّ على خلاف أنْ تكون معتنياً بالآمر، وبعد ذلك تتهم نفسك لأيِّ سبب آخر.
ويقول تعالى أيضاً في الإعراض: { { وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .. } [فصلت: 51] وسوف يأتي الجزاء على قدر الإعراض، كما بيَّن الحق سبحانه في قوله: { { وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ .. } [التوبة: 34-35].
كما نقول: أنت ربيتَ مَنْ سيقتلك فيما بعد، كذلك هؤلاء كنزوا الأموال ليتمتعوا بها قليلاً في دنيا فانية، ثم يلاقون تبعة ذلك يوم القيامة، نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، حتى يتمنى الواحد منهم - والعياذ بالله - لو أنه قلَّل منها حتى يُقلل من مواضع الكيِّ.
وتأمل هذا الترتيب: جباههم وجنوبهم وظهورهم، فسوف تجده نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذي سأل صاحب المال في الدنيا، فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه، ثم يعطيه جانبه، ثم يدير إليه ظهره، فيأتي الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله.
إذن: الإعراض تَرْك متعمَّد بلا مبالاة، أما السهو أو النسيان أو الخطأ أو عند النوم، فهذه كلها أمور مُعْفىً عنها، قد رفعها الله عنَّا رحمة بنا، فربُّك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل.
واقرأ إنْ شئتَ قول ربك: { { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ } [طه: 124].
لماذا؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر، فالنكبة فيه أشدُّ على خلاف أنْ تكون معتنياً بالآمر، وبعد ذلك تتهم نفسك لأيِّ سبب آخر.
ويقول تعالى أيضاً في الإعراض: { { وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .. } [فصلت: 51] وسوف يأتي الجزاء على قدر الإعراض، كما بيَّن الحق سبحانه في قوله: { { وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ .. } [التوبة: 34-35].
كما نقول: أنت ربيتَ مَنْ سيقتلك فيما بعد، كذلك هؤلاء كنزوا الأموال ليتمتعوا بها قليلاً في دنيا فانية، ثم يلاقون تبعة ذلك يوم القيامة، نار تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، حتى يتمنى الواحد منهم - والعياذ بالله - لو أنه قلَّل منها حتى يُقلل من مواضع الكيِّ.
وتأمل هذا الترتيب: جباههم وجنوبهم وظهورهم، فسوف تجده نفس ترتيب الإعراض عن المحتاج الذي سأل صاحب المال في الدنيا، فأول ما يراه يشيح عنه بوجهه، ثم يعطيه جانبه، ثم يدير إليه ظهره، فيأتي الجزاء من جنس العمل وبنفس تفاصيله.
فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض؟ يقول تعالى: { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ .. } [سبأ: 16] أي: بعد أن انهار سدُّ العرم، فسال ماؤه، فأغرقهم، ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك، وبه أهلك اللهُ قومَ نوح، وبه أهلك فرعونَ وجنوده، وهذا من طلاقة قدرة الله، حيث يوجه الشيء للحياة فيُحيى، وللهلاك فيُهلك.
وبعد أنْ أفزعهم سيل العرم لماذا أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا في أماكن لا ماء فيها، فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقِرَب، وكأن الماء أحدث لديهم (عقدة).
وبعد أنْ أفزعهم سيل العرم لماذا أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا في أماكن لا ماء فيها، فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقِرَب، وكأن الماء أحدث لديهم (عقدة).
وهذه القضية القديمة لها عندنا قصة حديثة: كنا ونحن في الأزهر نلبس (القفاطين) و (الكواكيل)، وكان لنا زميل حالته رقيقة، وكان لا يملك إلا (كاكولة) واحدة لبسها حتى بليت وتمزقت، فكان يمدّ يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن يداريه، حت صارت عادة عنده، ثم رزقه الله بأخ له توظف واشترى له (كاكولة) جديدة، فلما لبسها صارت يده تمتد إلى نفس الموضع، وتحاول ستر القطع الغير موجود في الجديدة، فقال له أحد الزملاء: ما لك؟ فقال: القديمة رعباني.
والسيل: أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشرَّبت منه قَدْر حاجتها، فما فاض عليها سال من مكان لآخر، والحق سبحانه يعلمنا: قبل أنْ نبحث عن مصادر الماء لا بُدَّ أنْ نبحث عن مصارفه حتى لا يغرقنا، واقرأ: { { وَقِيلَ يٰأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ أَقْلِعِي .. } [هود: 44].
فالأمر الأول للأرض أنْ تبلع الماء وتتشرَّبه، ثم يا سماء أمسكي ماءك؛ لذلك إذا تشبَّعت الأرض بالماء نقول: الأرض (عنِّنت) يعني: امتلأت بالمياه الجوفية، فإنْ كانت أرضاً زراعية لا تُخْرِج زرعاً، وإن كانت في المدن أضرَّت بالمباني، وفاضتْ في الشوارع وكسرت المواسير ... إلخ، ويعرف أهمية الصرف مَنْ يتعاملون مع الأرض.
وسيل العَرِم منسوب إلى العرم، وله إطلاقات متعددة، فالعرم هي الحجارة التي تُبنى بها السدود، أو هو الجُرْذ (الفأر) الذي نقب السد، وأحدث به فجوة نفذ منها الماء، فوسّعها وجعلها عيناً.
وقد رأينا ما فعله الماء في تحطيم خط بارليف، حيث هدى الله أحد مهندسينا جزاه الله خيراً إلى فكرة استخدام ضَخِّ الماء بقوة لإزالة الساتر الترابي الذي كان عقبة في طريقنا للاستيلاء على هذا الخط المنيع وتحطيمه، وفعلاً كانت فكرة أدهشتْ العالم كله.
والعَرِم جمع مفرده عرمة مثل لَبِن ولبنة، لكن اللبن هو الطوب (النىّ) أو الطين، أما العرم فهو الطوب المتحجر.
وقد رأينا ما فعله الماء في تحطيم خط بارليف، حيث هدى الله أحد مهندسينا جزاه الله خيراً إلى فكرة استخدام ضَخِّ الماء بقوة لإزالة الساتر الترابي الذي كان عقبة في طريقنا للاستيلاء على هذا الخط المنيع وتحطيمه، وفعلاً كانت فكرة أدهشتْ العالم كله.
والعَرِم جمع مفرده عرمة مثل لَبِن ولبنة، لكن اللبن هو الطوب (النىّ) أو الطين، أما العرم فهو الطوب المتحجر.
ثم يقول سبحانه: { وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ .. } [سبأ: 16] من صفاتهما أنهما { ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ .. } [سبأ: 16] يعني: أبدلهم الله بالجنتين السابق وصفهما بجنتين أُخْريين، لكن ثمارهما { أُكُلٍ خَمْطٍ .. } [سبأ: 16] يعني: ثمر مُرّ تعافُه النفس، وأشجارهما { وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ } [سبأ: 16].
والأثل: هو شجر الطرفاء، وهو قليل النفع لا ثمر له، والسدر: هو شجر النبق المعروف، وهو شجر قليل الفائدة. فكيف يُسمى هذا جنة؟ قالوا: سماها الحق جنة على سبيل التهكم، وإلا فليس في الجنة مثل هذا الشجر. ونلحظ أن الحق سبحانه رحيم بهم حتى في العقاب، فلم يجعلها خاوية ولا شيء فيها.
والأثل: هو شجر الطرفاء، وهو قليل النفع لا ثمر له، والسدر: هو شجر النبق المعروف، وهو شجر قليل الفائدة. فكيف يُسمى هذا جنة؟ قالوا: سماها الحق جنة على سبيل التهكم، وإلا فليس في الجنة مثل هذا الشجر. ونلحظ أن الحق سبحانه رحيم بهم حتى في العقاب، فلم يجعلها خاوية ولا شيء فيها.
ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلماً لهم، إنما جزاء ما فعلوا { ذَٰلِكَ .. } [سبأ: 17] يعني: ما سبق ذِكْره من الأكل الخمط والأثل والسدر { جَزَيْنَاهُمْ .. } [سبأ: 17] أي: جزاءً لهم { بِمَا كَفَرُواْ .. } [سبأ: 17] والكفر سَتْر النعمة، وهؤلاء ستروا نعمة الله حين ظنوا أنهم يأكلون من جَهْدهم وسعيهم وملكهم، وستروا نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه، فما أطاعوا في { { كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ .. } [سبأ: 15] وما أطاعوا في { { وَٱشْكُرُواْ لَهُ .. } [سبأ: 15].
ثم يُنزه الحق سبحانه نفسه بهذا الاستفهام التقريري: { وَهَلْ نُجَٰزِيۤ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ } [سبأ: 17] وجاء بالكفور وهي صيغة مبالغة، ولم يقل سبحانه: الكافر، وهذا من رحمته سبحانه بعباده، فهو سبحانه لا يجازي منهم إلاَّ الكفور أي: المُصِرّ على الكفر المتمادي فيه.
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ )١٨
هذه نعمة أخرى يمتنُّ الله بها على أهل سبأ، فمعنى { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ .. } [سبأ: 18] بين أهل سبأ { وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا .. } [سبأ: 18] والمراد بلاد الشام التي قال الله فيها قصة الإسراء: { { سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ } [الإسراء: 1].
والقرى جمع قرية، وهي اسم لمكان متواضع البناء، به مقومات الحياة الضرورية، فإذا نزلْتَه وجدت به قِرَى يعني طعاماً وشراباً.
ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام، فجعل الله لهم في طريق تجارتهم { قُرًى ظَاهِرَةً .. } [سبأ: 18] يعني: متقاربة متواصلة، كانت بمثابة استراحات في الطريق مثل (الرست) وذلك لبُعْد المسافة بين اليمن والشام في رِحْلَتْي الشتاء والصيف، فأراد الحق سبحانه أنْ يُيسِّر لهم تلك الرحلات، وأنْ يقطعوها بلا مشقة.
{ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ .. } [سبأ: 18] يعني: جعلنا سيرهم على مسافات متقاربة، فالقرى الظاهرة لهم في سيرهم والقريبة منهم بحيث يمرون بها ويروْنَها على طريقهم بلا مشقة، قرى مُوزَّعة على مسافات الطريق، بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سابلة الطريق.
وهذا يعني أنهم سيأمنون، لا يخيفهم شيء، وأنهم لا يحتاجون لِحَمْل زاد، فالقرى التى سيمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق، ويجدون بها حاجتهم، وهذا أيضاً يعني أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل.
والسير أي في الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة، ثم يُؤنسهم الحق سبحانه بهذا الأمر { سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ } [سبأ: 18] بحيث يسير في الغدوة إلى مكان يقيل فيه، ويسير في الرواح إلى مكان يبيت فيه يعني: محطة للقيلولة ومحطة للبيتوتة. وهذا السير في ظل أمن وأمان ضَمِنه لهم الحق سبحانه، فلا يروعهم شيء لا من الناس، ولا من الوحوش.
وهذا يعني أنهم سيأمنون، لا يخيفهم شيء، وأنهم لا يحتاجون لِحَمْل زاد، فالقرى التى سيمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق، ويجدون بها حاجتهم، وهذا أيضاً يعني أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل.
والسير أي في الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة، ثم يُؤنسهم الحق سبحانه بهذا الأمر { سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ } [سبأ: 18] بحيث يسير في الغدوة إلى مكان يقيل فيه، ويسير في الرواح إلى مكان يبيت فيه يعني: محطة للقيلولة ومحطة للبيتوتة. وهذا السير في ظل أمن وأمان ضَمِنه لهم الحق سبحانه، فلا يروعهم شيء لا من الناس، ولا من الوحوش.
وحين نقارن بين قوله تعالى هنا { آمِنِينَ } [سبأ: 18] وبين قوله تعالى عن قريش: { { ٱلَّذِيۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ } [قريش: 4] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف، وهنا قال { آمِنِينَ } [سبأ: 18] ولم يَقُل من خوف؛ لأن معنى { آمِنِينَ } [سبأ: 18] أي: الأمن التام آمنين من الخوف، وآمنين من الجوع؛ لأنه لم يُذكر مع { آمِنِينَ } [سبأ: 18] متعلق.
(فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)١٩
تامل هذا التعنت وهذا البطر لنعمة الله، حيث لم يعجبهم أنْ قَاربَ الله لهم بين القرى، فطلبوا { رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا } [سبأ: 19] يعني: افصل بين هذه القرى بصحارٍ شاسعة، بحيث لا يستطيع السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة على الحمل.
إذن: نظرتهم في هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع وطمع، فهم يريدون أنْ يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر للتجارة معهم، فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول الطريق، فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدَتْ له الأخرى من بعيد، فهذا يُسهِّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة، فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس، فواحد على جواد، وواحد على ناقة، وواحد على حمار.
إذن: نظرتهم في هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع وطمع، فهم يريدون أنْ يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر للتجارة معهم، فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول الطريق، فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدَتْ له الأخرى من بعيد، فهذا يُسهِّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة، فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس، فواحد على جواد، وواحد على ناقة، وواحد على حمار.
وقُرْب المسافات بين القرى شجَّع الفقراء على السفر لرحلة الشام؛ لذلك طلب هؤلاء أنْ يباعد الله بين هذه القرى فهو مطلب جَشِع أنانى؛ لذلك قال تعالى بعدها: { وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ .. } [سبأ: 19] نعم ظلموا أنفسهم؛ لأنهم حرموها من الراحة التي جعلها الله لهم، وظلموا أنفسهم لأنهم أرادوا أنْ يحتكروا هذه التجارة، وألاَّ يخرج إليها غيرهم من الفقراء، أو ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم اكتمال الإيمان؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهؤلاء يحبون أنْ يستأثروا بالنعمة لأنفسهم، ويحرموا منها غيرهم.
لكن، كيف تكون المباعدة التي طلبوها في طريق تجارتهم؟ عرفنا من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فاستقامة الطريق تُيسِّر الحركة فيه، وتقلِّل الوقت والمجهود، والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض القرى لتبعد المسافة بينها، أو بأنْ يلتوي الطريق، أو يدور هنا وهناك.
لكن، كيف تكون المباعدة التي طلبوها في طريق تجارتهم؟ عرفنا من علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فاستقامة الطريق تُيسِّر الحركة فيه، وتقلِّل الوقت والمجهود، والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض القرى لتبعد المسافة بينها، أو بأنْ يلتوي الطريق، أو يدور هنا وهناك.
فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر { فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ .. } [سبأ: 19] أى: أحدوثة يتحدث بها الناس أو (حدوتة) تُحكى، كما لو وقع مجرم في أيدي رجال الشرطة، فجعلوه عبرة لغيره حتى تحاكَى الناس به، كذلك أهل سبأ جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت سيرتهم مثلاً يُضرب، يقولون في المثل العربي الدال على التفرُّق: تفرقوا أيدي سبأ، يعني: تفرقوا بعد اجتماع كما تفرَّق أهل سبأ.
ومعنى { وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ .. } [سبأ: 19] أي: التمزيق والتفريق بكل أنواعه وطرقه، بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما صَغُرَتْ { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ .. } [سبأ: 19] يعني: فيها عبر وعظات يستفيد منها العاقل في حياته.
ومعنى { وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ .. } [سبأ: 19] أي: التمزيق والتفريق بكل أنواعه وطرقه، بحيث يتناول التمزيق كل الأجزاء مهما صَغُرَتْ { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ .. } [سبأ: 19] يعني: فيها عبر وعظات يستفيد منها العاقل في حياته.
{ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } [سبأ: 19] صبار وشكور من صيغ المبالغة، صبَّار مبالغة من الصبر؛ لأن هؤلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم، وأرادوا أنْ يقطعوا عليهم سبيل النعمة، وأن يستأثروا به لأنفسهم وقد تكرر منهم ذلك؛ لذلك لم يقل لكل صبار؛ لأنهم تحملوا من الأذى ما يحتاج إلى صبر كثير.
وسبق أنْ قُلْنا: لو علم الظالم ما أعدَّه الله للمظلوم لضَنَّ عليه بالظلم، ويكفي المظلوم أن الله تعالى سيكون في جانبه يوم القيامة.
ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شِرَّته وعصبيته يريد أنْ يُكفِّر عن ظلمه، فيسعى في أبواب الخير، ويبني مسجداً مثلاً أو مدرسة ... إلخ يظن أن له ثوابها، والحقيقة أن الثواب لمن ظلمهم وأخذ أموالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: { { وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ } [الأنبياء: 47].
ومن الغباء أن الظالم حين يتنبه إلى ظلمه وتهدأ شِرَّته وعصبيته يريد أنْ يُكفِّر عن ظلمه، فيسعى في أبواب الخير، ويبني مسجداً مثلاً أو مدرسة ... إلخ يظن أن له ثوابها، والحقيقة أن الثواب لمن ظلمهم وأخذ أموالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: { { وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ } [الأنبياء: 47].
وقال أيضاً { شَكُورٍ } [سبأ: 19] يعني: كثير الشكر لله أنْ أقْدره على أن يصبر؛ لذلك قالوا: ما صبرت وإنما صبَّرناك.
(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )20
{ وَلَقَدْ .. } [سبأ: 20] توكيد باللام مرة وبقد أخرى { صَدَّقَ .. } [سبأ: 20] حقق وأكد { عَلَيْهِمْ .. } [سبأ: 20] على أهل سبأ وأمثالهم ممَّن اتبعوه { إِبْلِيسُ ظَنَّهُ .. } [سبأ: 20] ما ظَنُّ إبليس؟ ظنُّه أن شهوات البشر ستُمكِّنه من إغوائهم، ونحن نعلم قصته لمَّا أمره الله بالسجود لآدم فأَبَى وقال مهدداً: { { بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ } [الأعراف: 16] وقال: { { فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } [ص: 82] وكان لا يزال فيه بقية من حياء، فقال: { { إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ } [الحجر: 40].
فظنُّ إبليس أنه قال: لقد أغويتُ أباهم وقدرْتُ عليه حين أغويته، فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخَلْق وأقواهم، وقد كلَّفه الله مباشرة وكلَّفه بشيء واحد، وهو أنْ يأكل من كل ثمار الجنة، عدا هذه الشجرة، ومع ذلك قدرْتُ عليه. إذن: فأنا أقدر على ذريته؛ لأنهم أقلُّ منه قوةً، وقد كلَّفهم الله تكليفاً غير مباشر، وكلَّفهم بتكاليف متعددة، فأنا أقدر عليهم من قدرتي على أبيهم.
وهذا الظن من إبليس ليس عِلْماً للغيب، إنما هو قياس قاس ذرية آدم على أبيهم، فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وكلَّفه مباشرة ولم يُكلِّفه إلا بأمر واحد، ومع ذلك قدرْت عليه فأنا على ذريته أقدر، هذا قياس لم يصل إليه إبليس ولايةً ولا كرامةً؛ لذلك سماه ظناً.
فظنُّ إبليس أنه قال: لقد أغويتُ أباهم وقدرْتُ عليه حين أغويته، فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخَلْق وأقواهم، وقد كلَّفه الله مباشرة وكلَّفه بشيء واحد، وهو أنْ يأكل من كل ثمار الجنة، عدا هذه الشجرة، ومع ذلك قدرْتُ عليه. إذن: فأنا أقدر على ذريته؛ لأنهم أقلُّ منه قوةً، وقد كلَّفهم الله تكليفاً غير مباشر، وكلَّفهم بتكاليف متعددة، فأنا أقدر عليهم من قدرتي على أبيهم.
وهذا الظن من إبليس ليس عِلْماً للغيب، إنما هو قياس قاس ذرية آدم على أبيهم، فإذا كان آدم هو المخلوق الأول الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وكلَّفه مباشرة ولم يُكلِّفه إلا بأمر واحد، ومع ذلك قدرْت عليه فأنا على ذريته أقدر، هذا قياس لم يصل إليه إبليس ولايةً ولا كرامةً؛ لذلك سماه ظناً.
فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال: ظني جاء في محله؛ لأنهم بالفعل اتبعوه { وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ .. } [سبأ: 20] ثم يأتي هذا الاستثناء { إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } [سبأ: 20] فجاء هذا الاستثناء مطابقاً للاستثناء الأول { { إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ } [الحجر: 40].
(وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفُيظٌ )21
ما أغوى إبليس بني آدم هل لهم عذر في هذا الإغواء؟ وهل الذنب هنا ذنب إبليس؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر في سياق قصة سبأ: { وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ .. } [سبأ: 21]، وقد التقط إبليس هذه العبارة وجعلها حُجَّة له يوم القيامة، فإذا قال له البشر يوم القيامة: أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال: { { وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوۤاْ أَنفُسَكُمْ .. } [إبراهيم: 22].
يعني: لا تلوموني ولا تظلموني، فقد كنتم (على تشويره) مني، وليس لي عليكم من سلطان: لا سلطان قوة أقهركم بها وأجبركم على طاعتي، ولا سلطان حجة أقنعكم به، والفرق بين سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض فأنت مُكْره، أمّا مع سلطان الحجة والمنطق فإنك تفعل ما يُطلَب منك عن رضا واقتناع.
يعني: لا تلوموني ولا تظلموني، فقد كنتم (على تشويره) مني، وليس لي عليكم من سلطان: لا سلطان قوة أقهركم بها وأجبركم على طاعتي، ولا سلطان حجة أقنعكم به، والفرق بين سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض فأنت مُكْره، أمّا مع سلطان الحجة والمنطق فإنك تفعل ما يُطلَب منك عن رضا واقتناع.
وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه، وعلمنا أننا لن نقهره إلا بالله خصوصاً بهذه (الروشتة) التي قال الله فيها: { { وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ .. } [فصلت: 36].
مجرد أنْ تُذكِّره بالله يخنس ويهرب ويتراجع، فهو يقدر عليك وحدك، فإنْ لجأتَ إلى ربك خاف وفَرَّ؛ لأنه لا قدرةَ له، ولا كيد مع ذكر الله، لذلك
قال بعض العارفين: قل هذه الكلمة بقوة وكأنك تراه وتصرعه.
فماذا نفعل إنْ جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن؟ قالوا: يقطع قراءته، ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد حاولنا أن نُقرِّب هذا المعنى لأذهان الناشئة فقلنا: لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس في (الشرفة) ليلاً، فرأى لصاً يحاول دخول بيته، فقام من مكانه، وقال (إحم) ماذا يصنع اللص؟ يهرب، فإنْ قال في نفسه لعلها مصادفة، ثم عاد في الليلة التي بعدها، فتنبَّه له صاحب البيت، وقال (إحم) عندها يفرّ بلا عودة، فصاحب البيت متنبه غير غافل.
كذلك، قَوْل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يُفزع الشيطان ويطرده، فإنْ عاد إليك مرة ومرة فقُلْ كلما شعرت بوسوسته ونزغاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندها سيعلم أنك (فقسته)، وأنه لا مدخل له إليك.
فماذا نفعل إنْ جاء لأحدنا وهو يقرأ القرآن؟ قالوا: يقطع قراءته، ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد حاولنا أن نُقرِّب هذا المعنى لأذهان الناشئة فقلنا: لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس في (الشرفة) ليلاً، فرأى لصاً يحاول دخول بيته، فقام من مكانه، وقال (إحم) ماذا يصنع اللص؟ يهرب، فإنْ قال في نفسه لعلها مصادفة، ثم عاد في الليلة التي بعدها، فتنبَّه له صاحب البيت، وقال (إحم) عندها يفرّ بلا عودة، فصاحب البيت متنبه غير غافل.
كذلك، قَوْل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يُفزع الشيطان ويطرده، فإنْ عاد إليك مرة ومرة فقُلْ كلما شعرت بوسوسته ونزغاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندها سيعلم أنك (فقسته)، وأنه لا مدخل له إليك.
وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم، فقال: { { لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ } [الأعراف: 16] فهو كما ذكرنا، لا يقعد في خمارة مثلاً، إنما يقعد في المسجد، فهو يعلم أنك في عبادة، وكُل مُناه أنْ يُفسِد عليك عبادتك، أَلاَ تراه يُذكّرك في الصلاة ما نسيتَ من مهمات الحياة، وعلى المؤمن أنْ يقدِّر موقفه بين يدي الله، وألاّ ينشغل بأي شيء وهو في حضرة ربه.
فالصلاة هي الصراط المستقيم الذي سيقعد لك الشيطانُ عليه؛ لذلك علَّمنا فقهاؤنا - رحمهم الله ورضي الله عنهم - أنْ نغيظ الشيطان، فإذا وسوس لك في الصلاة بحيث لا تدري، أصليتَ ركعتين أم ثلاثاً، فاعتبرها ركعتين وابْنِ على الأقل، كذلك في الوضوء وأمثاله من العبادات، لتغيظه وتُيئسه منك.
وظاهرة السهو في الصلاة في الحقيقة ظاهرة صحية فهي الإيمان، فلا تُمرِض نفسك بها، وكُنْ قويَّ الإيمان وتشجِّع على هذا العدو، وقُلْ له: لن أعطيك الفرصة لتفسد عليَّ لقائي مع ربي، قل هذا (واشخط شخطة إيمان) فإنك تحرقه، وإن عاد فَعُدْ، واعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفاً { { إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفاً } [النساء: 76].
فلا قدرة له عليك ما دُمْت في معية الله، وما دُمْت ذاكراً لله، عندك تنبُّه إيماني، وتنبُّه عقدي.
وسبق أنْ حكينا قصة الإمام أبي حنيفة لما جاءه رجل يستفتيه ويقول: يا إمام، لقد كنتُ أخفيتُ مالاً في مكان في الصحراء، وعلَّمته بحجر، فجاء السيل فطمسه حتى ضللتُ مكانه، فضحك الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرُّس ومَلَكة في الفتيا: يا بنى ليس في هذا علم، لكني سأحتال لك، اذهب بعد أنْ تصلي العشاء، فتوضأ وضوءاً جديداً بنية أنْ يهديك الله إلى ضالتك وصَلِّ لله ركعتين، ثم أخبرني ماذا حدث.
فعل الرجل ما أوصاه به الإمام، فجاءه إبليس ليفسد عليه صلاته وقال له: إن المال في مكان كذا وكذا، فراح فوجد المال، ثم عاد إلى الإمام فأخبره فقال: والله لقد علمتُ أن الشيطان لا يدعك تُتِم ليلتك مع ربك.
إذن: فَثِق بكلمة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وقُلْها بقوة إيمان، أيقول الله قَوْلة يأتي واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها؟ وجَرِّبها أنت بنفسك.
فعل الرجل ما أوصاه به الإمام، فجاءه إبليس ليفسد عليه صلاته وقال له: إن المال في مكان كذا وكذا، فراح فوجد المال، ثم عاد إلى الإمام فأخبره فقال: والله لقد علمتُ أن الشيطان لا يدعك تُتِم ليلتك مع ربك.
إذن: فَثِق بكلمة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وقُلْها بقوة إيمان، أيقول الله قَوْلة يأتي واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها؟ وجَرِّبها أنت بنفسك.
وقوله تعالى: { إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ .. } [سبأ: 21] ما دام أنه ليس لإبليس سلطان على بني آدم، وما دام أنهم على (تشويرة) منه، فلا بُدَّ أنَّ إيمانهم غير راسخ، وأنهم نَسُوا حكماً من أحكام الله؛ لأنه سبحانه حذرهم منه ووصف لهم طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا.
فكانت غواية إبليس لهم { لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ .. } [سبأ: 21] أي: عِلْم وقوع، وإلا فالحق سبحانه يعلم ما سيكون منهم أزلاً، لكن لا بُدَّ أنْ يحدث منهم الفعل لتقوم الحجة عليهم كالمعلم الذى يرى على تلميذه علامات الفشل، فيحذره، فحين يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتي يعاتب أستاذه أنه بشَّره بالرسوب فيقول المعلم: وهل أمسكتُ بيدك ومنعتُك من الإجابة، لقد حكمتُ عليك من خلال المقدمات التي رأيتها منك.
ومع ذلك كان من الممكن أنْ يغشَّ هذا التلميذ في الامتحان وينجح رغم ما قاله المعلم؛ لأن علمه عِلْمٌ ناقص، أما علم الحق سبحانه فعِلْم تام. إذن: فعِلْم الوقوع ألزم للحجة.
ثم يقول سبحانه: { وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفُيظٌ } [سبأ: 21] حفيظ صيغة مبالغة من الحفظ، فالله تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق وعلى العلم وعلى كل شيء، كما قال سبحانه: { { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ } [الحجر: 21] وما دام الله تعالى هو الحفيظ، فلا أحدَ يستطيع أنْ يخل بهذه القضية.
التفاسير العظيم
- مشاركات امانى يسرى
- عدد المواضيـع :
- عدد الـــــــردود :
- المجمــــــــــوع : 3,807
 قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فوائد هامة للشيخ ابن تيمية ،فوائد من المجلد العاشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن | أم أمة الله | المنتدي الاسلامي العام | 1 | 17-10-2019 05:56 PM |
| ايات القران التي تتكلم عن: الحساب و اليوم الاخر | أم أمة الله | القرآن الكريم | 3 | 08-04-2019 08:53 AM |
| الطب النبوي | لؤلؤة الاسلام 1 | الطب البديل | 55 | 09-11-2018 02:02 AM |
| الإيمان باليوم الآخر والحساب | بشرى على | العقيدة الإسلامية | 5 | 06-11-2017 10:26 AM |
| المتحابون في الله على غير أرحام بينهم | ام عشتار | المنتدي الاسلامي العام | 19 | 18-06-2014 10:20 PM |
الساعة الآن 04:14 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع